من دون ضجيج – مع بعض الهواجس بشأن وضعها الجديد – تجاوزت الصين للتو الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم. هذه دعوة للاستيقاظ وينبغي أن تكون كذلك – لكنها يقظة ليست من النوع الذي قد يتخيله معظم الأمريكيين.
بقلم جوزيف ستيغليتز
4 ديسمبر 2014
عندما يُكتب تاريخ 2014، فإنه سيلاحظ حقيقة كبيرة لم تحظ باهتمام كبير: كان عام 2014 آخر عام يمكن أن تدعي فيه الولايات المتحدة أنها أكبر قوة اقتصادية في العالم. تدخل الصين عام 2015 في المركز الأول، حيث من المحتمل أن تظل لفترة طويلة جدًا، إن لم يكن إلى الأبد. وبذلك تعود إلى المكانة التي احتلتها عبر معظم تاريخ البشرية.
من الصعب للغاية مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المختلفة. تتوصل اللجان الفنية إلى تقديرات، بناءً على أفضل الأحكام الممكنة، لما يسمى “تعادل القوة الشرائية”، والتي تمكن من مقارنة الدخل في مختلف البلدان. لا ينبغي اعتبار هذه الأرقام دقيقة، لكنها توفر أساسًا جيدًا لتقييم الحجم النسبي للاقتصادات المختلفة. في أوائل عام 2014، أصدرت الهيئة التي تجري هذه التقييمات الدولية – برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي – أرقامًا جديدة. (كان تعقيد المهمة كبيرا لدرجة أنه لم يكن هناك سوى ثلاثة تقارير خلال 20 عامًا). لكن التقييم الأخير، الذي صدر الربيع الماضي، أكثر إثارة للجدل، وفي بعض النواحي، الأكثر أهمية من تلك التقارير التي صدرت في السنوات السابقة. كان الأمر أكثر إثارة للجدل على وجه التحديد لأنه كان الأكثر أهمية: أظهرت الأرقام الجديدة أن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم في وقت أقرب بكثير مما كان يتوقعه أي شخص – كانت في طريقها للقيام بذلك قبل نهاية عام 2014.
قد يفاجئ مصدر الخلاف العديد من الأمريكيين، وهو يقول الكثير عن الاختلافات بين الصين والولايات المتحدة – وحول مخاطر إسقاط بعض مواقفنا على الصينيين. يرغب الأمريكيون كثيرًا في أن يكونوا رقم واحد – فنحن نستمتع بهذا المكانة. في المقابل، الصين ليست حريصة على ذلك. وفقًا لبعض التقارير، هدد المشاركون الصينيون حتى بالانسحاب من المناقشات الفنية. لسبب واحد، لم ترغب الصين في وضع رأسها فوق الحاجز – فكونها الأولى لها ثمن. ويعني ذلك دفع المزيد لدعم الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة. كما يمكن أن يمارس ضغوطا للقيام بدور قيادي مستنير في قضايا مثل تغير المناخ. ما قد يدفع الصينيون العاديون إلى التساؤل عما إذا كان ينبغي إنفاق المزيد من ثروة البلاد على تلك القضايا. (كانت الأخبار حول تغيير وضع الصين محجوبة في الواقع عن الداخل الصيني). كان هناك أيضا مصدر قلق آخر، وكان مصدر قلق عميق: حيث تفهم الصين جيدًا انشغال أمريكا النفسي بكونها رقم واحد – وكانت قلقة للغاية بشأن ما سيكون رد الفعل الأمريكي حيث لم نعد بتلك المرتبة.
بالطبع ومن نواح كثيرة – على سبيل المثال، من حيث الصادرات ومدخرات الأسرة – تجاوزت الصين منذ زمن بعيد الولايات المتحدة. نظرًا لأن المدخرات والاستثمارات تشكل ما يقرب من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الصينيين قلقون بشأن امتلاك الصينيين الكثير من المدخرات، تمامًا كما يقلق الأمريكيون بشأن امتلاك القليل جدًا منها. وفي مجالات أخرى، كالتصنيع تفوق الصينيون على الولايات المتحدة فقط خلال السنوات القليلة الماضية. كما لا يزال الصينون يتتبعون أمريكا عندما يتعلق الأمر بعدد براءات الاختراع الممنوحة، لكنهم يقلصون الفجوة.
المجالات التي تظل فيها الولايات المتحدة قادرة على منافسة الصين فيها، ليست دائمًا تلك التي نرغب بشدة في لفت الانتباه إليها. كلا البلدين لديهما مستويات متماثلة من عدم المساواة. (بلدنا هو الأعلى في العالم المتقدم). تتفوق الصين على أمريكا في عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم كل عام، لكن الولايات المتحدة تتقدم كثيرًا عندما يتعلق الأمر بنسبة السكان القابعين في السجن (أكثر من سبعمئة لكل مئة ألف شخص). تفوقت الصين على الولايات المتحدة في عام 2007 كأكبر ملوث في العالم، من حيث الحجم الإجمالي، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تحت الصدارة على أساس نصيب الفرد. تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية الأكبر، حيث تنفق على القوات المسلحة أكثر مما تنفقه الدول العشر التالية مجتمعة (لا يعني ذلك أننا استخدمنا قوتنا العسكرية بحكمة على الدوام). لكن القوة الأساسية للولايات المتحدة كانت دائمًا تعتمد بدرجة أقل على القوة العسكرية الصارمة بقدر ما تعتمد على “القوة الناعمة”، وعلى الأخص نفوذها الاقتصادي. هذه نقطة أساسية يجب تذكرها.
من الواضح أن التحولات التكتونية في القوة الاقتصادية العالمية قد حدثت مسبقا، ونتيجة لذلك فإننا نعرف شيئًا عما حدث عندما يحدث فعلا. قبل مائتي عام، في أعقاب الحروب النابليونية، برزت بريطانيا العظمى كقوة مهيمنة على العالم. امتدت إمبراطوريتها على ربع الكرة الأرضية. وأصبحت عملتها، الجنيه الإسترليني، العملة الاحتياطية العالمية – مثل الذهب تماما. فرضت بريطانيا، التي تعمل أحيانًا بالتنسيق مع حلفائها، قواعدها التجارية الخاصة. يمكنها التمييز ضد استيراد المنسوجات الهندية وتجبر الهند على شراء الأقمشة البريطانية. كما يمكن لبريطانيا وحلفائها أيضًا الإصرار على إبقاء الصين على أسواقها مفتوحة للأفيون، وعندما حاولت الصين، وهي تعلم التأثير المدمر للمخدرات، وردا على إغلاق الصين حدودها، أدى بالحلفاء للذهاب إلى الحرب مرتين للحفاظ على التدفق الحر لهذا المنتج إلى الأسواق الصينية.
استمرت هيمنة بريطانيا مائة عام واستمرت حتى بعد أن تجاوزتها الولايات المتحدة اقتصاديًا في سبعينيات القرن التاسع عشر. هناك دائمًا إدراك متأخر (كما سيكون الحال مع الولايات المتحدة والصين). كان الحدث الانتقالي هو الحرب العالمية الأولى، عندما انتصرت بريطانيا على ألمانيا وفقط بمساعدة الولايات المتحد. بعد الحرب ، كانت أمريكا مترددة في قبول مسؤولياتها الجديدة المحتملة بالقدر الذي كان عليه التردد البريطاني بالتخلي طواعية عن دورها. فعل وودرو ويلسون ما في وسعه لبناء عالم ما بعد الحرب، بحيث يقلل من احتمال حدوث صراع عالمي آخر، لكن الانعزال في الداخل عنت أن الولايات المتحدة لن تنضم أبدًا إلى عصبة الأمم. في المجال الاقتصادي، أصرت أمريكا على السير في طريقها الخاص – بتمرير تعريفات سموت هاولي الجمركية وإنهاء حقبة شهدت ازدهارًا عالميًا في التجارة. حافظت بريطانيا على إمبراطوريتها، لكن الجنيه الإسترليني أفسح المجال أمام الدولار: ففي النهاية، تهيمن الحقائق الاقتصادية. أصبحت العديد من الشركات الأمريكية شركات عالمية، ومن الواضح أن الثقافة الأمريكية كانت في صعود.
كانت الحرب العالمية الثانية هي الحدث المركزي التالي. بعد أن دمرها الصراع، ستفقد بريطانيا قريبًا جميع مستعمراتها تقريبًا. لكن في هذه المرة تولت الولايات المتحدة عباءة القيادة. لقد كان محوريًا في إنشاء الأمم المتحدة وصياغة اتفاقيات بريتون وودز ، والتي من شأنها أن تشكل أساس النظام السياسي والاقتصادي الجديد. ومع ذلك ، كان السجل متفاوتًا. بدلاً من إنشاء عملة احتياطي عالمية ، والتي كان من شأنها أن تسهم كثيرًا في الاستقرار الاقتصادي العالمي – كما جادل جون ماينارد كينز بحق – وضعت الولايات المتحدة مصلحتها الذاتية قصيرة الأجل أولاً ، معتقدةً بحماقة أنها ستكسب من خلال جعل الدولار يصبح العملة الاحتياطية في العالم. يعتبر وضع الدولار نعمة مختلطة: فهو يمكّن الولايات المتحدة من الاقتراض بسعر فائدة منخفض ، حيث يطلب الآخرون الدولارات لوضعها في احتياطياتهم ، ولكن في نفس الوقت ترتفع قيمة الدولار (أعلى مما كان يمكن أن يكون لولا ذلك) ، مما يؤدي إلى حدوث عجز تجاري أو تفاقمه وإضعاف الاقتصاد.
لمدة 45 عامًا بعد الحرب العالمية الثانية، هيمنت على السياسة العالمية قوتان عظميان، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يمثلان رؤيتين مختلفتين تمامًا حول كيفية تنظيم وإدارة الاقتصاد والمجتمع والأهمية النسبية للحقوق السياسية والاقتصادية. في نهاية المطاف، فشل النظام السوفييتي، وكان ذلك لحد كبير بسبب الفساد الداخلي، دون رادع من قبل الآليات الديمقراطية، مثل أي شيء آخر. كانت قوته العسكرية هائلة. ولكن قوته الناعمة مزحة بشكل متزايد. أصبح العالم الآن تحت سيطرة قوة عظمى واحدة استمرت في الاستثمار بكثافة في جيشها. ومع ذلك كانت الولايات المتحدة قوة عظمى ليس فقط عسكريًا ولكن اقتصاديًا بنفس القدر.
ثم ارتكبت الولايات المتحدة خطأين فادحين. الأولى كانت أن استنتجت الولايات المتحدة أن انتصارها يعني انتصارًا لكل شيء تمثله. ولكن في كثير من دول العالم الثالث، ظلت المخاوف بشأن الفقر – والحقوق الاقتصادية التي دافع عنها اليسار منذ فترة طويلة – لها الأولوية. الخطأ الثاني هو استخدام الفترة القصيرة من هيمنتها أحادية الجانب، بين سقوط جدار برلين وسقوط ليمان بروذرز، لتحقيق مصالحها الاقتصادية الضيقة – أو بشكل أكثر دقة، المصالح الاقتصادية متعددة الجنسيات، بما في ذلك بنوكها الكبرى – بدلاً من إنشاء نظام عالمي جديد ومستقر. كان النظام التجاري الذي دفعت به الولايات المتحدة في عام 1994، عندما أنشأت منظمة التجارة العالمية، غير متوازن لدرجة أنه بعد خمس سنوات، حيث كانت اتفاقية تجارية أخرى وشيكة، أدى هذا الاحتمال إلى أعمال شغب في سياتل. إن الحديث عن التجارة الحرة والعادلة، مع الإصرار (على سبيل المثال) على الإعانات المقدمة لمزارعيها الأغنياء، قد صور الولايات المتحدة على أنها منافقة وتخدم مصالحها الذاتية.
ولم تدرك واشنطن أبدًا عواقب هذا العدد الكبير من أفعالها القصيرة النظر – التي تهدف إلى توسيع هيمنتها وتعزيزها، ولكنها في الواقع تقلل من موقعها على المدى الطويل. خلال الأزمة المالية الآسيوية، في التسعينيات عملت وزارة الخزانة الأمريكية بجد لتقويض ما يسمى بمبادرة ميازاوا، التي تضمنت عرض اليابان السخي بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الاقتصادات التي كانت تغرق في الركود والكساد. كانت السياسات التي دفعت بها الولايات المتحدة تجاه هذه البلدان – التقشف وأسعار الفائدة المرتفعة، مع عدم وجود عمليات إنقاذ للبنوك التي تعاني من المتاعب – هي عكس تلك التي دافع عنها نفس مسؤولي وزارة الخزانة للولايات المتحدة بعد الانهيار في عام 2008. لغاية اليوم، بعد عقد ونصف من أزمة شرق آسيا، يمكن لمجرد ذكر دور الولايات المتحدة أن يثير اتهامات غاضبة واتهامات بالنفاق في العواصم الآسيوية.
الآن الصين هي القوة الاقتصادية رقم واحد في العالم. لماذا علينا أن نهتم؟ على مستوى واحد، في الواقع لا ينبغي لنا ذلك. إن الاقتصاد العالمي ليس معادلة محصلتها صفر، حيث يجب أن يأتي نمو الصين بالضرورة على حسابنا. في الواقع نموها الاقتصادي مكمل لنمونا. فإن نما بشكل أسرع، فسوف تشتري الصين المزيد من بضائعنا، وسنزدهر. من المؤكد أنه كان هناك دائمًا القليل من الضجيج في مثل هذه الادعاءات – فقط لنسأل العمال الذين فقدوا وظائفهم الإنتاجية لصالح الصين. لكن هذا الواقع له علاقة بسياساتنا الاقتصادية في الداخل كما هو الحال مع صعود بعض البلدان الأخرى.
على مستوى آخر، فإن ظهور الصين في الصدارة أمر مهم للغاية، ونحن بحاجة إلى أن نكون على دراية بالتداعيات.
أولاً كما هو مؤكد، تكمن القوة الحقيقية لأمريكا في قوتها الناعمة – المثال الذي تقدمه للآخرين وتأثير أفكارها، بما في ذلك الأفكار حول النموذج الاقتصادي والسياسي. إن صعود الصين إلى المرتبة الأولى يجلب حضورا جديدًا للنموذج السياسي والاقتصادي لتلك الدولة – ولأشكال قوتها الناعمة. كما أن صعود الصين يسلط الضوء بشدة على النموذج الأمريكي. هذا النموذج لم يكن واضحا لجزء كبير من سكانها. الأسرة الأمريكية النموذجية هي أسوأ حالا مما كانت عليه قبل ربع قرن، مع تعديلها لمراعاة التضخم،فإن نسبة الفقراء قد ازدات بشكل كبير. تتميز الصين أيضًا بمستويات عالية من انعدام المساواة، لكن اقتصادها كان يفعل بعض الخير لمعظم مواطنيها. أخرجت الصين حوالي 500 مليون شخص من براثن الفقر خلال نفس الفترة التي شهدت دخول الطبقة الوسطى في أمريكا فترة من الركود. النموذج الاقتصادي الذي لا يخدم غالبية مواطنيها لن يقدم نموذجًا يحتذى به للآخرين لمحاكاته. يجب أن ترى أمريكا صعود الصين بمثابة دعوة للاستيقاظ لترتيب منزلها بالشكل السليم.
ثانيًا، إذا تأملنا مليا صعود الصين ثم اتخذنا إجراءات بناءً على مبدأ أن الاقتصاد العالمي هو بالفعل لعبة محصلتها صفر – وبالتالي فإننا بحاجة إلى زيادة حصتنا وتقليص الصين – فسوف نضعف قوتنا الناعمة أكثر. سيكون هذا بالضبط النوع الخاطئ من نداء الاستيقاظ. إذا رأينا أن مكاسب الصين تأتي على حسابنا، فعلينا أن نسعى جاهدين من أجل “الاحتواء”، واتخاذ خطوات مصممة للحد من نفوذ الصين. ستثبت هذه الإجراءات في النهاية أنها غير مجدية، لكنها مع ذلك ستقوض الثقة في الولايات المتحدة ومكانتها القيادية. لقد وقعت السياسة الخارجية للولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا في هذا الفخ. لنأخذ في الاعتبار ما يسمى بالشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارة حرة مقترحة بين الولايات المتحدة واليابان والعديد من الدول الآسيوية الأخرى – والتي تستثني الصين تمامًا. ينظر إليها من قبل الكثيرين على أنها وسيلة لتوثيق الروابط بين الولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية، على حساب الروابط مع الصين. هناك سلسلة إمداد واسعة وديناميكية في آسيا، حيث تتحرك البضائع في جميع أنحاء المنطقة خلال مراحل الإنتاج المختلفة؛ تبدو الشراكة عبر المحيط الهادئ وكأنها محاولة لعزل الصين عن سلسلة التوريد هذه.
مثال آخر: تنظر الولايات المتحدة بارتياب إلى جهود الصين الأولية لتحمل المسؤولية العالمية في بعض المجالات. تريد الصين أن تلعب دورًا أكبر في المؤسسات الدولية القائمة، لكن الكونجرس يقول، في الواقع إن النادي القديم لا يحب الأعضاء الجدد المفعمين بالنشاط: يمكنهم الاستمرار في شغل المقعد الخلفي، لكن لا يمكنهم الحصول على حقوق تصويت تتناسب مع دورهم في الاقتصاد العالمي. عندما تتفق دول مجموعة العشرين الأخرى على أن الوقت قد حان لتحديد قيادة المنظمات الاقتصادية الدولية على أساس الجدارة وليس على أساس الجنسية، فإن الولايات المتحدة تصر على أن النظام القديم جيد بما فيه الكفاية. كما يجب أن يبقى البنك الدولي خاضعا لإدارة رئيس أمريكي الجنسية، على سبيل المثال.
مثال آخر: عندما اقترحت الصين، جنبًا إلى جنب مع فرنسا ودول أخرى – بدعم من لجنة الخبراء الدولية التي عينها رئيس الأمم المتحدة، والتي ترأستها شخصيا – أن ننهي العمل الذي بدأه كينز في بريتون وودز، من خلال إنشاء عملة احتياطية دولية، قطعت الولايات المتحدة الطريق على تلك المساعي.
والمثال الأخير: سعت الولايات المتحدة إلى ردع جهود الصين لتوجيه المزيد من المساعدات إلى البلدان النامية من خلال المؤسسات المتعددة الأطراف المنشأة حديثًا والتي سيكون للصين فيها دور كبير، وربما مهيمن. لقد تم الاعتراف على نطاق واسع بالحاجة إلى تريليونات الدولارات من الاستثمار في البنية التحتية – وتوفير هذا الاستثمار يتجاوز بكثير قدرة البنك الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف القائمة. ما نحتاجه ليس فقط نظام حوكمة أكثر شمولية في البنك الدولي ولكن أيضًا المزيد من رأس المال. في كلا النقطتين، قال الكونجرس الأمريكي لا. وفي الوقت ذاته، تحاول الصين إنشاء الصندوق الآسيوي للبنية التحتية، والعمل مع عدد كبير من البلدان الأخرى في المنطقة، التي تلوي الولايات المتحدة أذرعها حتى لا تنضم تلك الدول.
تواجه الولايات المتحدة تحديات حقيقية في السياسة الخارجية من الصعب حلها: الإسلام المتشدد، الصراع الفلسطيني الذي دخل عقده السابع، روسيا العدوانية، التي تصر على تأكيد قوتها، على الأقل في محيطها؛ التهديدات المستمرة للانتشار النووي. سنحتاج إلى تعاون الصين لمعالجة العديد من هذه المشاكل، إن لم يكن جميعها.
يجب أن ننتهز هذه اللحظة، حيث أصبحت الصين أكبر اقتصاد في العالم، من أجل “توجيه” سياستنا الخارجية بعيدًا عن الاحتواء. المصالح الاقتصادية للصين والولايات المتحدة متشابكة بشكل معقد. كلانا لديه مصلحة في رؤية نظام سياسي واقتصادي عالمي مستقر ويعمل بشكل جيد. بالنظر إلى الذكريات التاريخية وإحساسها الخاص بالكرامة، لن تتمكن الصين من قبول النظام العالمي القائم كما هو ببساطة، مع القواعد التي وضعها الغرب، لإفادة الغرب ومصالحه المؤسسية، والتي تعكس النظام الغربي. سيتعين علينا التعاون، شئنا أم أبينا – كما يجب علينا أن نريد ذلك التعاون. في غضون ذلك، فإن أهم شيء يمكن لأمريكا أن تفعله للحفاظ على قيمة قوتها الناعمة هو معالجة أوجه القصور في نظامها الخاص، وليكن الأمر جلي الوضوح، والمتمثل في الفساد في الممارسات الاقتصادية والسياسية والميل نحو الأغنياء وذوي النفوذ.
نظام سياسي واقتصادي عالمي جديد آخذ في الظهور نتيجة حقائق اقتصادية جديدة. لا يمكننا تغيير هذه الحقائق الاقتصادية. ولكن إذا استجبنا لها بطريقة خاطئة، فإننا نخاطر برد فعل عنيف سيؤدي إما إلى نظام عالمي مختل أو نظام عالمي ليس ما كنا نريده.




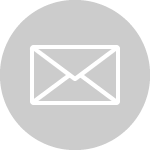
0 تعليق