لقد خضع الاقتصاد الهندي لتدقيق أكبر مع تكثيف المناقشة حول ما إذا كانت البلاد ستكون “الصين التالية”.
كانت الصين محركًا رئيسيًا للنمو العالمي لمدة ثلاثة عقود تقريبًا حيث ساهمت بأكثر من ربع توسع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين عامي 1990 و2020 وفي الفترة من عام 2013 إلى عام 2021 ساهمت الصين بنحو 39% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي – أي أكثر بنسبة 13% من دول مجموعة السبع مجتمعة.
وبالتالي فإن محاكاة الصين تتطلب من الهند الحفاظ على معدل نمو مزدوج الرقم تقريبًا لمدة ثلاثة عقود تقريبًا والتكامل مع سلسلة التوريد التصنيعية العالمية والانتقال إلى قوة تصديرية وجذب استثمارات أجنبية هائلة. وفي حين أن هذه مهمة شاقة فإن الهند تجد نفسها في مفترق طرق فريد من نوعه حيث وقفت الصين قبل أكثر من 40 عامًا.
كان صعود الصين نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية رئيسية شكلت العالم في سبعينيات القرن العشرين. دفعت الجغرافيا السياسية في تلك الفترة, التي اتسمت بالتنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والانقسام الصيني السوفييتي, الغرب بقيادة الولايات المتحدة إلى الانفتاح على الصين في عام 1971 وقد وفر هذا ظروفًا مواتية حيث أطلقت الصين إصلاحات في أواخر السبعينيات.
وهناك ميل مماثل داخل الغرب تجاه الهند اليوم بسبب المنافسة الاستراتيجية المتزايدة مع الصين. لقد أثار نفوذ بكين الدبلوماسي والاقتصادي المتوسع والذي تجلى في سياستها الخارجية العدوانية والإكراه الاقتصادي مخاوف من الإفراط في الاعتماد والضعف الاستراتيجي في الغرب وقد أجبر هذا بدوره الولايات المتحدة وحلفاءها على إعادة تقييم شراكتهم مع الصين واستكشاف خيارات الحد من المخاطر والتنويع مع ظهور الهند كشريك مفضل.
كان هناك عامل آخر عمل لصالح الصين في الماضي وهو أن التحول الجيوسياسي المذكور أعلاه تزامن مع وقت كانت فيه الشركات العالمية في سعيها إلى تحقيق قدر أعظم من القدرة التنافسية تبحث بنشاط عن وجهات خارجية في آسيا لخفض تكاليف التشغيل المتزايدة. وبالمناسبة في أعقاب التقارب بين الصين والولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين أصبحت السوق الصينية التي تتمتع بحوض ضخم من العمالة الرخيصة خيارًا مربحًا.
ومرة أخرى تجري عملية إعادة تنظيم مماثلة. لقد دفع التنافس الصيني الأمريكي المتعمق واشنطن إلى فرض قيود تصدير أحادية ومتعددة الأطراف على الشركات الصينية لتقييد وصولها إلى السلع التكنولوجية الرئيسية. كما فرضت الصين متطلبات امتثال تنظيمية صارمة على الشركات الأجنبية كإجراء متبادل وبدافع من التحدي التنظيمي المزدوج الذي فرضته واشنطن وبكين تسعى الشركات الأجنبية العاملة في الصين إلى إعادة توجيه استثماراتها الجديدة بعيدًا عن الصين ومن هنا ظهرت الهند كبديل جدير بالثقة.
ويبدو أن الحكومة الهندية أيضًا تميل إلى تحقيق أقصى استفادة من المكاسب الناجمة عن استراتيجية الحد من المخاطر وهو ما يتجلى في اهتمامها الشديد بدعم المشاريع البارزة التي تنطوي على تصنيع هواتف آيفون وتجميع أشباه الموصلات.
وأخيرًا كانت الصين تتمتع بميزة قاعدة مستهلكين متنامية لم تكن لدى أي من منافسيها الآسيويين وهو الأمر الذي منحها ميزة لا مثيل لها. وعلى هذا فقد أصبحت سوق المستهلكين لديها ذات أهمية متزايدة في التأثير على قرارات الأعمال في العقود التالية. وبمرور الوقت تم تعويض الجوانب السلبية لارتفاع أجور العمالة في الصين من خلال القدرة التنافسية الماهرة لعمالتها وقاعدة المستهلكين المتوسعة.
وتتمتع الهند بميزة مماثلة اليوم فهي تفتخر حاليًا بثاني أكبر قاعدة مستهلكين ــ والتي تعرف بأنها الأشخاص الذين ينفقون أكثر من 12 دولارا في اليوم ــ والتي تضم أكثر من 500 مليون نسمة وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين التي تضم 900 مليون نسمة وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 سوف تتوسع قاعدة المستهلكين في الهند إلى 773 مليون نسمة لتتخلف عن الصين التي تضم 1.062 مليار نسمة فقط وسوف تتقلص الفجوة بين الصين والهند من هنا فصاعدًا.
ومع ذلك تواجه رحلة الهند تعقيدات متعددة وأهمها صعود الحماية التجارية في جميع أنحاء العالم وإعادة إدخال السياسات الصناعية حتى داخل قلب الاقتصادات الرأسمالية الليبرالية.
لقد ركبت المعجزة الصينية موجة العولمة التي بدأت حوالي عام 1980 واستمرت حتى أزمة الأسواق المالية العالمية في عام 2008 ولكن المنطق الاقتصادي الذي تقوم عليه العولمة تعرض لضغوط شديدة في الآونة الأخيرة فقد أدى الميل إلى تسليح التجارة إلى جعل الدول أكثر حذرًا في التعامل مع الإكراه الاقتصادي.
وقد شجعت الإجبارات السياسية المحلية الدول على السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في شكل أو آخر وحتى أبرز أنصار التجارة الحرة لجأوا إلى تقديم إعانات عائمة في الداخل لتشجيع إعادة الاستثمارات إلى الوطن وبالتالي فإن العولمة المعوقة تشكل أكبر قوة موازنة ضد طموحات الهند ويتفاقم هذا بسبب إحجام الهند عن الاستفادة من ما تبقى من العولمة وهو ما يتجلى في لجوئها إلى فرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات وتشككها في اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف.
ومع ذلك هناك مكاسب يمكن استخلاصها من استراتيجيات الحد من المخاطر و”الصين زائد واحد” الجارية وإن لم تكن بالحجم الذي كانت عليه في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. ورغم أن الهند برزت كمنافس قوي في هذه المنافسة اللاحقة فإنها تواجه منافسة شرسة من دول مثل فيتنام وتايلاند وماليزيا والتي تهدد بتقليص مكاسبها من حيث القيمة المطلقة والنسبية.
وأشارت غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين إلى أنه في حين كان أداء الهند أفضل من أي دولة في جنوب شرق آسيا واجتذبت 15% من الاستثمارات الأوروبية المتنوعة بعيدًا عن الصين فإنها تأخرت عن رابطة دول جنوب شرق آسيا ككل والتي اجتذبت 21% من الاستثمارات المعاد توجيهها.
وأخيرًا في حين أن السوق الاستهلاكية الكبيرة يمكن أن تمنح الهند ميزة لا مثيل لها في مواجهة منافسيها فإن التجربة تشير إلى أنها عامل من الدرجة الثالثة في التأثير على الاستثمارات الواردة. وهذا واضح في حقيقة أن سنغافورة وفيتنام وماليزيا وتايلاند ــ وكلها ذات أسواق محلية أصغر كثيرًا ــ اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة أعلى كثيرًا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشكل الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وسهولة ممارسة الأعمال عوامل رئيسية لخلق النمو وفيما يتصل بالانفتاح يضع مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الهند على قدم المساواة مع منافسيها أو حتى أفضل منهم ولكن عندما يتعلق الأمر بسهولة ممارسة الأعمال فإن الهند تتخلف كثيرًا عن الركب مما يمنع سوقها الاستهلاكية من تحفيز الاستثمار الوارد. وتساهم الهند حاليًا بنحو 16% من النمو الاقتصادي العالمي في مقابل 34% للصين ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع حصة الهند إلى 18% في السنوات الخمس المقبلة. ومع انخفاض حصة الصين في المستقبل بسبب تباطؤها الاقتصادي فإن الهند في وضع استراتيجي يسمح لها بالظهور كمحرك رئيسي للنمو شريطة أن تتغلب على التحديات المذكورة أعلاه بمهارة.
نبذة عن الكاتب: أميت كومار هو محلل أبحاث في برنامج دراسات المحيطين الهندي والهادئ التابع لمؤسسة تاكشاشيلا (Takshashila).
اقرأ أيضًا: صناعة السينما السعودية تدعو هوليوود لرعاية المواهب المحلية
المصدر: نيكاي آسيا




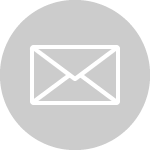
0 تعليق