لم تكن لتخمن ذلك، نظرًا للضجيج المحيط بمعدل النمو بنسبة 0.8٪ للربع الأول من عام 2014، إن الناس في المملكة المتحدة يعيشون فترة أسوأ من فترة “العقد الضائع” سيئة السمعة في اليابان في التسعينيات.
خلال ذلك الوقت، نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 1٪ سنويًا. وهذا يعني أنه في عام 2000، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان أعلى بنسبة 10.5٪ مما كان عليه في عام 1990. وفي المملكة المتحدة، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013 أقل بنسبة 6.6٪ من مثيله في عام 2007. وهذا يعني أنه ما لم ينمو اقتصاد المملكة المتحدة بأعجوبة حوالي 5٪ سنويًا على مدى السنوات الأربع المقبلة (مع الأخذ في الاعتبار معدل النمو السكاني بحوالي 0.7٪ سنويًا)، سيكون هناك عقد “ضائع” أشد من عقد التسعينيات في اليابان.
كانت تكاليف أزمة عام 2008 من حيث رفاهية الإنسان أكبر مما تشير إليه أرقام النمو. لا تزال البطالة تقارب 7٪، أو 2.24 مليون، مما يحرم الناس من الكرامة ويضعهم تحت ضغط هائل. شهدت الأجور الحقيقية بعض أكبر الانخفاضات في كتلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 34 دولة، ولا يزال أمامها طريق طويل قبل أن تتمكن من التعافي إلى مستويات ما قبل الأزمة.
أثرت التخفيضات الحادة في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بشدة على العديد من أفقر الناس. أدى تزايد انعدام الأمن الوظيفي، الذي يرمز إليه بازدياد عقود العمل ذات ساعات عمل صفرية، إلى جعل حياة العمال أكثر إرهاقًا. إن انتشار بنوك الطعام، وشعبية “وصفات الفقر” في الطبخ، وتطور سلاسل متاجر السوبر ماركت الألمانية، مثل آلدي (Aldi) و ليدل (Lidl)، هي المظاهر الأكثر وضوحًا لهذا الضغط على المستويات المعيشية للمواطنين.
والأكثر من ذلك، أنه حتى هذا الإنجاز المؤسف تم تحقيقه مع العودة إلى النموذج الاقتصادي الذي كشفت أزمة عام 2008 إفلاسه. استند هذا النموذج إلى النظام المالي غير المنظم الذي يغذي النمو غير المستدام من خلال خلق فقاعات الأصول، وهي واحدة من أعلى ديون الأسر في العالم (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، وعجز كبير في الحساب الجاري.
كيف خلقت هذه الفوضى؟ إن سوء إدارة الحكومة الائتلافية للأزمة يعني أن عليها أن تتحمل مسؤولية كبيرة، لكن السبب الرئيسي يكمن في طبيعة النموذج الاقتصادي الذي اتبعته المملكة المتحدة على مدى ثلاثة عقود.
بدأ هذا النموذج، كما هو معروف، مع مارغريت تاتشر. لقد مزقت إجماع ما بعد الحرب العالمية الثانية حول الاقتصاد المختلط وبدأت في إنشاء أحد أكثر الاقتصادات تحررًا في العالم الغني. تم التخلي عن العمالة الكاملة كهدف وأضعفت حقوق العمال. تمت خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وغالبًا ما كانت لها عواقب سلبية للغاية، كما هو الحال في السكك الحديدية والمياه والطاقة. والأهم من ذلك، أن تحريرها المالي الضخم قد مهد الطريق لتطوير رأسمالية مالية حرة، والتي تقع طبيعتها المدمرة في قلب الفوضى الحالية.
اتخذت الحكومات العمالية اللاحقة أقسى الحدود من التاتشرية، على سبيل المثال، من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وإدخال الحد الأدنى للأجور. ومع ذلك، ظل النموذج الاقتصادي الأساسي على حاله؛ كان تفكير حزب العمال الجديد هو أننا يجب أن نسمح للمدينة بمضاعفة أرباحها من خلال تقليل التنظيم، ومن ثم مساعدة الفقراء في الضرائب على تلك الأرباح. لم يكن هناك إدراك أن النظام المالي نفسه قد يكون مشكلة.
بعد فترة وجيزة عندما أحدثت ضجيجًا حول إعادة التوازن إلى الاقتصاد و”المجتمع الكبير”، قامت الحكومة الائتلافية باندفاع متهور لصالح تاتشر بلس. صحيح أنه عزز التنظيم المالي إلى حد ما، لكنه في الوقت نفسه دعم البنوك أيضًا للخياشيم، صراحة (عمليات الإنقاذ) وضمنيًا (التيسير الكمي). واتباعًا لمبدأ الميزانية المتوازنة، فقد خفض الإنفاق في منتصف فترة الركود، مما أدى إلى تأخير خطير في الانتعاش. لقد قامت بإجراء تخفيضات على دولة الرفاهية التي كانت تاتشر نفسها قد وجدتها جذرية، بينما خصخصت “رأس الملكة” (البريد الملكي)، والتي رفضت حتى بيعها.
بالطبع، من المفترض أن تكون كل هذه السياسات مدعومة بنظريات اقتصادية مثبتة علميًا – تقول إن من الأفضل ترك الأسواق بمفردها، وأن جعل الأغنياء أكثر ثراءً يجعل الجميع أكثر ثراءً، وأن الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وحماية حقوق العمال لا يؤديان إلا إلى جعل الناس كسالى واتكاليين. لقد قبل معظم الناس هذه النظريات دون الكثير من التساؤل لأنها تستند إلى نصيحة “الخبراء”.
ومع ذلك، فإن كل هذه النظريات الاقتصادية قابلة للنقاش على الأقل وغالبًا ما تكون موضع شك كبير. على عكس ما سيخبرك به الاقتصاديون المحترفون، فإن الاقتصاد ليس علمًا. تحتوي جميع النظريات الاقتصادية على افتراضات سياسية وأخلاقية أساسية، مما يجعل من المستحيل إثبات صحتها أو خطأها بالطريقة التي يمكننا بها مع نظريات الفيزياء أو الكيمياء. هذا هو السبب في وجود عشرات المدارس في الاقتصاد، مع نقاط القوة والضعف الخاصة بكل منها، مع ثلاثة أنواع لاقتصاديات السوق الحرة وحدها – الكلاسيكية، والكلاسيكية الجديدة، والنمساوية.
بالنظر إلى هذا، من الممكن تمامًا للأشخاص غير الاقتصاديين المحترفين أن يكون لديهم أحكام سليمة بشأن القضايا الاقتصادية، بناءً على بعض المعرفة بالنظريات الاقتصادية الرئيسية وتقدير الافتراضات السياسية والأخلاقية الكامنة وراء النظريات المختلفة. في كثير من الأحيان، قد تكون الأحكام الصادرة عن المواطنين العاديين أفضل من تلك الصادرة عن الاقتصاديين المحترفين، لأنها أكثر تجذرًا في الواقع وأقل تركيزًا.
في الواقع، فإن الاستعداد لتحدي الاقتصاديين المحترفين وغيرهم من الخبراء هو حجر الأساس للديمقراطية. إذا كان كل ما علينا فعله هو الاستماع إلى الخبراء، فما الهدف من وجود ديمقراطية؟
ما يعنيه هذا هو أنه، كمواطنين في نظام ديمقراطي، علينا جميعًا واجب تعلم بعض علم الاقتصاد على الأقل والمشاركة في المناقشات الاقتصادية. هذا ليس بالصعوبة التي قد يبدو عليها. كما أحاول أن أعرض في كتابي الجديد، الاقتصاد: دليل المستخدم، يمكن لأي شخص لديه تعليم ثانوي أن يفهم معظم علم الاقتصاد، إذا تم شرحه بسهولة.
الاقتصاد مهم للغاية بحيث لا يمكن تركه للاقتصاديين المحترفين (وهذا يشملني). كمواطنين، يجب علينا جميعًا أن نتعلم الاقتصاد ونتحدى ما يقول لنا المهنيون أن نصدقه.
قرأ أيضاً أكبر مشكلة تواجه الصناعة المصرفية ليست المكافآت أو الحصة السوقية.
بقلم ها جوون تشانغ، بتاريخ 30. إبريل 2014، نقلاً عن الغارديان.




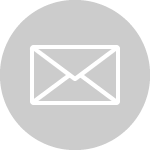
0 تعليق